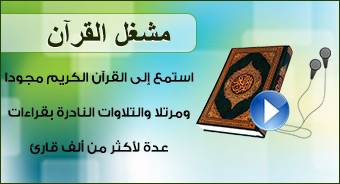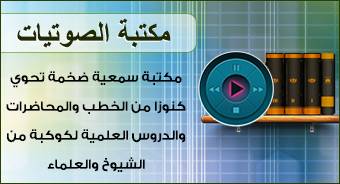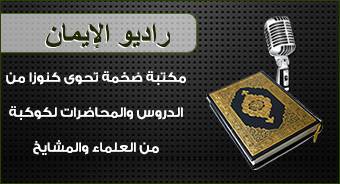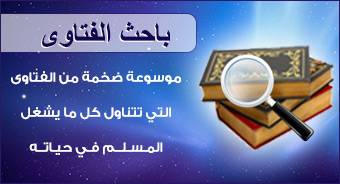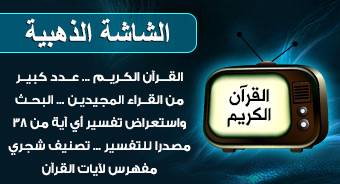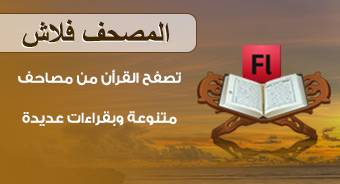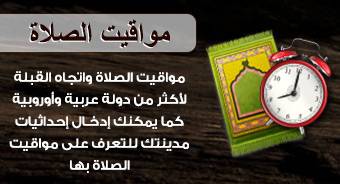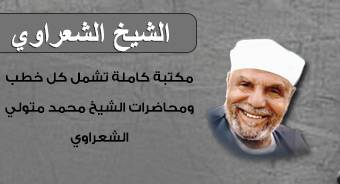.قال الشوكاني:
.قال الشوكاني:
قوله:
{قُلْ هُوَ الله أحد}الضمير يجوز أن يكون عائدًا إلى ما يفهم من السياق لما قدمنا من بيان سبب النزول، وأن المشركين قالوا: يا محمد انسب لنا ربك.فيكون مبتدأ، والله مبتدأ ثان.و
{أحد} خبر المبتدأ الثاني، والجملة خبر المبتدأ الأوّل.ويجوز أن يكون
{الله} بدلًا من
{هو}، والخبر
{أحد}.ويجوز أن يكون الله خبرًا أوّلًا، و
{أحد} خبرًا ثانيًا، ويجوز أن يكون
{أحد} خبرًا لمبتدأ محذوف، أي: هو أحد.ويجوز أن يكون
{هو} ضمير شأن؛ لأنه موضع تعظيم، والجملة بعده مفسرة له وخبر عنه، والأوّل أولى.قال الزجاج: هو كناية عن ذكر الله، والمعنى: إن سألتم تبيين نسبته
{قُلْ هُوَ الله أحد}.قيل: وهمزة
{أحد} بدل من الواو، وأصله وأحد.وقال أبو البقاء: همزة
{أحد} أصل بنفسها غير مقلوبة، وذكر أن أحد يفيد العموم دون وأحد.ومما يفيد الفرق بينهما ما قاله الأزهري: أنه لا يوصف بالأحدية غير الله تعالى، لا يقال رجل أحد، ولا درهم أحد؛ كما يقال رجل واحد، ودرهم وأحد.قيل: والواحد يدخل في الأحد، والأحد لا يدخل فيه فإذا قلت لا يقاومه وأحد جاز أن يقال لكنه يقاومه اثنان بخلاف قولك لا يقاومه أحد.وفرّق ثعلب بين وأحد وبين أحد بأن الواحد يدخل في العدد وأحد لا يدخل فيه.وردّ عليه أبو حيان بأنه يقال أحد وعشرون، ونحوه، فقد دخله العدد، وهذا كما ترى، ومن جملة القائلين بالقلب الخليل.قرأ الجمهور:
{قل هو الله أحد} بإثبات
{قل}.وقرأ عبد الله بن مسعود وأبيّ:
{الله أحد} بدون
{قل}.وقرأ الأعمش:
{قل هو الله الواحد} وقرأ الجمهور: بتنوين
{أحد}، وهو: الأصل.وقرأ زيد بن علي، وأبان بن عثمان، وابن أبي إسحاق، والحسن، وأبو السماك، وأبو عمرو في رواية عنه بحذف التنوين للخفة، كما في قول الشاعر:
عمرو الذي هشم الثريد لقومه ** ورجال مكة مسنتون عجافوقيل: إن ترك التنوين لملاقاته لام التعريف، فيكون الترك لأجل الفرار من التقاء الساكنين.ويجاب عنه بأن الفرار من التقاء الساكنين قد حصل مع التنوين بتحريك الأوّل منهما بالكسر
{الله الصمد} الإسم الشريف مبتدأ، و
{الصمد} خبره.والصمد: هو الذي يصمد إليه في الحاجات، أي: يقصد لكونه قادرًا على قضائها، فهو فعل بمعنى مفعول كالقبض بمعنى المقبوض؛ لأنه مصمود إليه، أي: مقصود إليه، قال الزجاج: الصمد السند الذي انتهى إليه السؤدد.فلا سيد فوقه، قال الشاعر:
ألا بكر الناعي بخير بني أسد ** بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمدوقيل: معنى الصمد: الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزول.وقيل: معنى الصمد ما ذكر بعده من أنه الذي لم يلد ولم يولد.وقيل: هو المستغني عن كل أحد، والمحتاج إليه كل أحد.وقيل: هو المقصود في الرغائب، والمستعان به في المصائب، وهذان القولان يرجعان إلى معنى القول الأوّل.وقيل: هو الذي يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد.وقيل: هو الكامل الذي لا عيب فيه.وقال الحسن، وعكرمة، والضحاك، وسعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، ومجاهد، وعبد الله بن بريدة، وعطاء، وعطية العوفي، والسديّ، الصمد هو المصمت الذي لا جوف، ومنه قول الشاعر:
شهاب حروب لا تزال جياده ** عوابس يعلكن الشكيم المصمداوهذا لا ينافي القول الأوّل لجواز أن يكون هذا أصل معنى الصمد، ثم استعمل في السيد المصمود إليه في الحوائج، ولهذا أطبق على القول الأوّل أهل اللغة وجمهور أهل التفسير، ومنه قول الشاعر:
علوته بحسام ثم قلت له ** خذها حذيف فأنت السيد الصمدوقال الزبرقان بن بدر:
سيروا جميعًا بنصف الليل واعتمدوا ** ولا رهينة إلاّ سيد صمدوتكرير الاسم الجليل؛ للإشعار بأن من لم يتصف بذلك، فهو بمعزل عن استحقاق الألوهية، وحذف العاطف من هذه الجملة؛ لأنها كالنتيجة للجملة الأولى.وقيل: إن الصمد صفة للاسم الشريف، والخبر هو ما بعده.والأوّل أولى؛ لأن السياق يقتضي استقلال كل جملة.
{لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولد} أي: لم يصدر عنه ولد، ولم يصدر هو عن شيء، لأنه لا يجانسه شيء، ولاستحالة نسبة العدم إليه سابقًا ولاحقًا.قال قتادة: إن مشركي العرب قالوا: الملائكة بنات الله.وقالت اليهود: عزير ابن الله.وقالت النصارى: المسيح ابن الله، فأكذبهم الله فقال:
{لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولد}.قال الرازي: قدّم ذكر نفي الولد مع أن الولد مقدّم للاهتمام، لأجل ما كان يقوله الكفار من المشركين: إن الملائكة بنات الله، واليهود: عزير ابن الله، والنصارى: المسيح ابن الله، ولم يدّع أحد أن له والدًا، فلهذا السبب بدأ بالأهمّ، فقال:
{لَمْ يَلِدْ} ثم أشار إلى الحجة فقال:
{وَلَمْ يُولد}، كأنه قيل: الدليل على امتناع الولد اتفاقنا على أنه ما كان ولدا لغيره، وإنما عبّر سبحانه بما يفيد انتفاء كونه لم يلد ولم يولد في الماضي، ولم يذكر ما يفيد انتفاء كونه كذلك في المستقبل؛ لأنه ورد جوابًا عن قولهم: ولد الله، كما حكى الله عنهم بقوله:
{أَلاَ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقولونَ ولد الله} [الصافات: 151، 152] فلما كان المقصود من هذه الآية تكذيب قولهم، وهم: إنما قالوا ذلك بلفظ يفيد النفي فيما مضى، وردت الآية لدفع قولهم هذا.
{وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أحد} هذه الجملة مقرّرة لمضمون ما قبلها؛ لأنه سبحانه إذا كان متصفًا بالصفات المتقدمة كان متصفًا بكونه لم يكافئه أحد، ولا يماثله ولا يشاركه في شيء، وأخر اسم كان لرعاية الفواصل، وقوله:
{له} متعلق بقوله:
{كفوًا} قدم عليه لرعاية الاهتمام؛ لأن المقصود نفي المكافأة عن ذاته.وقيل: إنه في محل نصب على الحال، والأوّل أولى.وقد ردّ المبرد على سيبويه بهذه الآية؛ لأن سيبويه قال: إنه إذا تقدّم الظرف كان هو الخبر، وههنا لم يجعل خبرًا مع تقدّمه، وقد ردّ على المبرد بوجهين:أحدهما: أن سيبويه لم يجعل ذلك حتمًا بل جوّزه.والثاني أنا لا نسلم كون الظرف هنا ليس بخبر، بل يجوز أن يكون خبرًا ويكون كفوًا منتصبًا على الحال وحكى في الكشاف عن سيبويه على أن الكلام العربيّ الفصيح أن يؤخر الظرف الذي هو لغو غير مستقرّ، واقتصر في هذه الحكاية على نقل أوّل كلام سيبويه، ولم ينظر إلى أخره، فإنه قال في آخر كلامه: والتقديم والتأخير والإلغاء، والاستقرار عربيّ جيد كثير.انتهى.قرأ الجمهور:
{كفوًا} بضم الكاف والفاء، وتسهيل الهمزة.وقرأ الأعرج، وسيبويه، ونافع في رواية عنه بإسكان الفاء، وروي ذلك عن حمزة مع إبداله الهمزة واوًا وصلًا ووقفًا.وقرأ نافع في رواية عنه:
{كفأ} بكسر الكاف، وفتح الفاء من غير مدّ.وقرأ سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس كذلك مع المد، وأنشد قول النابغة:
لا تقذفني بركن لا كفاء لهوالكفء في لغة العرب النظير.يقول: هذا كفؤك أي: نظيرك، والاسم الكفاءة بالفتح.وقد أخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والمحاملي في أماليه، والطبراني، وأبو الشيخ في العظمة عن بريد لا أعلمه إلاّ رفعه.قال:
{الصمد} الذي لا جوف له، ولا يصح رفع هذا.وأخرج ابن المنذر، وابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال:
{الصمد} الذي لا جوف له، وفي لفظ: ليس له أحشاء.وأخرج ابن أبي عاصم، وابن جرير، وابن المنذر، والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس مثله.وأخرج ابن المنذر عنه قال:
{الصمد} الذي لا يطعم، وهو المصمت.وقال: أو ما سمعت النائحة، وهي تقول:
لقد بكر الناعي بخير بني أسد ** بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمدوكان لا يطعم عند القتال، وقد روي عنه أن الذي يصمد إليه في الحوائج، وأنه أنشد البيت، واستدلّ به على هذا المعنى، وهو أظهر في المدح، وأدخل في الشرف، وليس لوصفه بأنه لا يطعم عند القتال كثير معنى.وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ في العظمة، والبيهقي في الأسماء والصفات من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال:
{الصمد} السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغنيّ الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه هذه صفة لا تنبغي إلاّ له ليس له كفو وليس كمثله شيء.وأخرج ابن أبي حاتم، وابن جرير، وابن المنذر، والبيهقي عن ابن مسعود قال:
{الصمد} هو السيد الذي قد انتهى سؤدده، فلا شيء أسود منه.وأخرج ابن أبي حاتم، وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس قال:
{الصمد} الذي تصمد إليه الأشياء إذا نزل بهم كربة أو بلاء.وأخرج ابن جرير من طرق عنه في قوله:
{وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أحد} قال: ليس له كفو ولا مثل. اهـ.
 .قال صاحب روح البيان:
.قال صاحب روح البيان:
{قُلْ هُوَ اللَّهُ أحد}الضمير للشأن كقولك هو زيد منطلق وارتفاعه بالابتداء وخبره الجملة ولا حاجة إلى العائد لأنها عين الشان الذي عبر عنه بالضمير أي الله أحد هو الشأن هذا أو هو أن الله أحد والسر في تصدير الجملة به التنبيه من أول الأمر على فخامة مضمونها مع أن في الإبهام ثم التفسير مزيد تقرير أو الضمير لما سئل عنه أي الذي سألتم عنه هو الله إذ روى إن المشركين قالوا للنبي عليه السلام، صف لنا ربك الذي تدعونا إليه وأنسبه أي بين نسبه وذاكره فنزلت يعني بين الله نسبه بتنزيهه عن النسب حيث نفى عنه الوالدية ولمولودية والكفاءة فالضمير حينئذٍ مبتدأوخبره وأحد بدل منه وإبدال النكرة المحضة من المعرفة يجوز عند حصول الفائدة على ما ذهب إليه أبو على وهو المختار والله أعلم.دال على الإله الحق دلالة جامعة لمعاني الأسماء الحسنى كلها.وقال القاشاني: هو عندنا اسم الذات الإلهية من حيث هي هي أي المطلقة الصادق عليها مع جميعها أو بعضها أو لا مع وأحد منها كقوله تعالى:
{قُلْ هُوَ اللَّهُ أحد} انتهى.وعبد الله هو العبد الذي تحلى بجميع أسمائه فلا يكون في عباده أرفع مقامًا وأعلى شأنا منه لتحققه بالاسم الأعظم واتصافه بجميع صفاته وهذا خص نبينا عليه السلام، بهذا الاسم في قوله وإنه لما قام عبد الله يدعوه فلم يكن هذا الاسم بالحقيقة إلا له وللأطاب من ورثته بتبعيته وإن أطلق على غيره مجازًا لاتصاف كل اسم من أسمائه بجميعها بحكم الواحدية وأحدية جميع الأسماء والأحد اسم لمن لا يشاركه شيء في ذاته كما أن الواحد اسم لمن لا يشاركه شيء في صفاته يعني أن الأحد هو الذات وحدها بلا اعتبار كثرة فيها فأثبت له الأحدية التي هي الغنى عن كل ما عداه وذلك من حيث عينه وذاته من غير اعتبار أمر آخر والواحد هو الذات مع اعتبار كثرة الصفات وهي الحضرة الإسمائية ولذا قال تعالى: إن إلهكم لوأحد ولم يقل لأحد لأن الواحدية من أسماء التقييد فبينها وبين الخلق ارتباط أي من حيث الآلهة والمألوهية بخلاف الأحدية إذ لا يصح ارتباطها بشيء فقولهم العلم الإلهي هو العلم بالحق من حيث الارتباط بينه وبين الخلق وانتشاء العالم منه بقدر الطاقة البشرية إذ منه ما لا تفيه الطاقة البشرية وهو ما وقع به الكمل في ورطة الحيرة وأقروا بالعجز عن حق المعرفة ومنه يعلم أن توحيد الذات مختص في الحقيقة بالله تعالى وعبد الأحد هو وحيد الوقت صاحب الزمان الذي له القطبية الكبرى والقيام بالأحدية الأولى وعبد الواحد هو الذي بلغه الله الحضرة الواحدية وكشف له عن أحدية جميع أسمائه فيدرك ما يدرك ويفعل ما يفعل بأسمائه ويشاهد وجود أسمائه الحسنى.قال ابن الشيخ في حواشيه قوله هو الله أحد ثلاثة ألفاظ كل واحد منها إشارة إلى مقام من مقامات السائرين إلى الله تعالى فالمقام الأول مقام المقربين وهم الذين نظروا إلى ماهيات الأشياء وحقائقها من حيث هي هي فلا جرم ما رأوا موجودًا سوى الله لأن الحق هو الذي لذاته يجب وجوده وإما ما عداه فممكن والممكن إذا نظر إليه من حيث هو هو كان معدومًا فهؤلاء لم يروا موجودًا سوى الحق تعالى وكلمة هو وإن كانت للإشارة المطلقة مفتقرة في تعين المراد بها إلى سبق الذكر بأحد الوجوه أو إلى أن يعقبها ما يفسرها إلا أنهم يشيرون بها إلى الحق ولا يفتقرون في تلك الإشرة إلا ما يميز المراد بها من غيره لأن الافتقار إلى الممز إنما يحصل حيث وقع الإبهام بأن يتعدد ما يصلح لأن يشار إليه وقد بينا إنهم لا يشاهدون بعيون عقولهم إلا الواحد فقط فلهذا السبب كانت لفظة هو كافية في حصول العرفان التام لهؤلاء والمقام الثاني مقام أصحاب اليمين وهو دون المقام الأول وذلك لأنهم شاهدوا الحق موجودًا وشاهدوا الخلق أيضًا موجودًا فحصلت الكثرة في الموجودات فلا جرم لم تكن لفظة هو كافية في الإشارة إلى الحق بل لابد هناك من مميز به يتميز الحق من الخلق فهؤلاء مفتقرون إلى أن يقرن لفظة الله بلفظة هو فقيل لأجلهم هو الله لأن لفظة الله اسم للموجود الذي يفتقر إليه ما عداه ويستغنى هو عن كل ما عداه فتتميز به الذات المرادة عما عداه والمقام الثالث مقام أصحاب الشمال وهو أخس المقامات وهم الذين يجوزون أن يكون واجب الوجود أكثر من وأحد فقرن لفظة الأحد بما تقدم ردًا على هؤلاء وإبطالًا لمقالهم فقيل قل هو الله أحد انتهى كلامه.ومنه يعلم صحة ما أعتاده الصوفية من الذكر بالاسم هو وذلك لأن أهل البداية منهم وهم المحجوبون تابعون لأهل النهاية منهم وهم المكاشفون كأنهم كلهم ما شاهدوا في الوجود إلا الله فالله عندهم بهويته المطلقة السارية متعين لا حاجة إلى التعيين أصلًا فضمير هو راجع إليه لا إلى يره كما أن الضمير في أنزلناه راجع إلى القرآن لتعينه وحضوره في الذهن فقول الطاعن إنه ضمير ليس له مرجع متعين فكيف يكون ذكر الله تعالى مردود على أن الضمائر أسماء وكل الأسماء ذكر لا فرق بينها بالمظهرية والمضمرية فعلى هذا يجوز أن يدخل اللام في كلمة هو في اصطلاح الصوفية لأنها إشارة إلى الهوية ولا مناقشة في الاصطلاح ثم قوله قل أمر من عين الجمع وارد على مظهر التفصيل وفيه إشارة إلى سر قوله تعالى شهد الله إنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم فكأنه يقول إنا شهدت بوحدة الهوية في مقام الجمع فأشهد أنت أيضًا بتلك الوحدة في مقام الفرق ليظهر سر الأحدية واللا حدية ويحصل التطابق بينهما جمعًا وتفصيلًا هكذا لاح بالبال والله أعلم بحقيقة الحالو قرئ هو الله بلا قل وكذا في المعوذتين لأنه توحيد والأخريان تعوذ فيناسب إن يدعو بهما وإن يؤمر بتبليغهما وقد سبق في سورة الأعلى ما يغنى عن تكراره هاهنا وقال بعضهم: إنما أثبت في المصحف قل والتزم في التلاوة مع إنه ليس من دأب المأمور بقل أن يتلفظ في مقام الائتمار إلا بالمقول لأن المأمور ليس المخاطب به فقط بل كل واحد ابتلى بما ابتلى به المأمور فأثبت ليبقى على مر الدهور منا على العباد.
{الله الصمد} مبتدأ وخبر فعل بمعنى مفعول كقبض بمعنى مقبوض من صمد إليه من باب نصر إذا قصد أي هو السيد المصمود إليه في الحوائج المستغنى بذاته وكل ما عداه محتاج إليه في جميع جهاته فلا صمد في الوجود سوى الله فهو مثل زيد الأمير يفيد قصر الجنس على زيد فإذ كان هو الصمد فمن انتفت الصمدية عنه لا يستحق الألوهية وتعريفه لعلمهم بصمديته بخلاف أحديته وتكرير الاسم الجليل للإشار بأن من يتصف به فهو بمعزل عن استحقاق الألوية كما أشير إليه آنفًا وتعرية الجملة عن العاطف لأنها كالنتيجة للأولى وبين أولًا أولهيته المستتبعة لكافة نعوت الكمال ثم أحديتة الموجبة لتنزهه عن شائبة التعدد والتركب بوجه من الوجوه وتوم المشاركة في الحقيقة وخواصها ثم صمديه المقتضية لاستغنائه الذاتيعما سواه وافتقار جميع المخلوقات إليه في وجودا وبقائها وسائر أحوالها تحقيقًا للحق وإرشادًا لم إلى سننه الواضح فإثبات الصمدية له سبحانه إنما هو باعتبار استنادنا إليه في الوجود والكمالات التابعة للوجود باعتبار أحدية ذته فهو غني عن هذه الصفة والحاصل إن الصمدية تقتضي اعتبار كثرة الأسماء والصفات في الله دون الأحدية وعبد الصمد هو مظهر الصمدية الذي يصمد إليه أي يقصد لدفع البليات وإيصال امداد اخيرات ويستشفع به إلى الله ادفع العذاب وإعطاء الثواب وهو محل نظر الله إلى العالم في ربوبيته له.يقول الفقير: جرى على لسان الباطن بلا اختيار منى وذلك بعد الإشراق إن أقول أزلي أبدي إحدى صمدي أي أنت يا رب أزلي أحدي وأبدي صمدي فالأزلية ناظرة إلى الأحدية كما أن الأبدية ناظرة إلى الصمدية وذلك باعتبار التحليل والتعقيد فإن الأحدية لا تتجلى إلا بإزالة الكثرت فعند الانتها إلى مقام الغنى الذي هو الغيب المطلق تزول الكثرة ويكون الزوال أزلًا وهذا تحليل وفناء وعبور عن المنازل وعروج إلى المرصد الأعلى والمقصد الأقصى عينًا وعلمًا وإما الصمدية فباعتبار الأبدية التي هي البقاء وذلك يقتضي التعقيد بعد التحليل فهي بالنزول إلى مقام العين بالمهملة أي العين الخارجي والعالم الشهادي الذي أسفل منازله عالم الناسوت والحاصل أن الأحدية جمع والصمدية فرق فمقام الأحدية هي النقطة الغير المنقسمة التي نبسطت منها جملة التراكيب الواحدية فأول تعيناتها هي مرتبة آدم ثم حواء لأن حواء إنما ظهرت بعد الهواء المنبعث من تعين آدم الحقيقي ولذا انقلبت الهاء حاء فصار الهواء حواء وخاصية الاسم الأحد ظهور عالم القدرة وآثارها حتى لو ذكره ألفًا في خلوة على طهارة ظهرت له العجائب بحسب قوته وضعفه وخاصية الاسم الصمد حصول الخير والصلاح فمن قرأه عند السحر مائة وخمسًا وعشرين مرة ظهرت عليه آثار الصدق والصديقية وفي اللمعة ذاكره لا يحس بألم الجوع ما دام ملتبسًا بذكره والقراءة وصلًا أحد الله الصمد منونًا مكسور الالتقاء الساكنين وكان أبو عمر وفي أكثر الروايات يسكت عند هو الله أحد وزعم أن العرب لا تصل مثل هذا وروى عنه إنه قال وصلها قراءة محدثة وروى عنه قال أدركت القراء كذلك يقرأونها قل هو الله أحدو إن وصلت نونت وروى عنه إنه قال أحب إلى إذا كان رأس آية أن يسكت عندها وذلك لأن الآية منقطعة عما بعدها مكتفية بمعناها فهي فاصلة وبها سميت آية وإما وقفهم كلهم فيسكتون على الدال ثم صرح ببعض أحكام جزئية مندرجة تحت الأحكام السابقة فقيل
{لَمْ يَلِدْ}تنصيصًا على إبطال زعم المفترين في حق الملائكة والمسيح ولذلك ورد النفي على صيغة الماضي من غير أن يقال لن يلد أولًا يلد أي لم يصدر عنه ولد لأنه لا يجانسه شي ليمكن أن يكون له من جنسه صاحبة فيتوالد أولًا يفتقر إلى ما يعينه أو يخلفه لاستحالة الحاجة والفناء عليه سبحانه.فإن قلت: لم قال في هذه السورة لم يلد وفي سورة بني إسرائيل لم يتخذ ولدا أجيب بأن النصارى فريقان منهم من قال عيسى ولد الله حقيقة فقوله لم يلد إشارة إلى الرد عليه ومنهم من قال اتخذه ولدا تشريفًا كما اتخذ إبراهيم خليلًا تشريفًا فقوله:
{لم يتخذ ولدا} إشارة إلى الرد عليه
{وَلَمْ يُولد}أي لم يصدر عن شيء لاستحالة نسبة العدم إليه سابقًا أولًا حقًا وقال بعضهم: الوالدية والمولودية لا تكونان إلا بالمثلية فإن المولود لابد أن يكون مثل الوالد ولا مثلية بين هويته الواجبة وهوياتنا الممكنة انتهى وقال البقلي لم يلد ولم يولد أي لم يكن هو محل الحوادث ولا الحوادث محله والتصريح بأنه لم يولد مع كونهم معترفين بمضمونه لتقرير ما قبله وتحقيقه بالإشرة إلى أنهما متلازمان إذ المعهود إن ما يلد يولد وما لا فلا ومن قضية الاعتراف بأنه لم يولد الاعتراف بأنه لا يلد وفي (كشف الأسرار) قدم ذكر لم يلد لأن من الكفار من ادعى إن له ولدا ولم يدع أحد إنه مولود.قال أبو الليث لم يلد يعني لم يكن له ولد يرثه ولم يولد يعني لم يكن له والد يرث ملكه
{وَلَمْ يَكُن لَّه كُفُوًا أحد} يقال هذا كفاؤه وكفؤه مثله وكافأ فلانًا ماثله وله صلة لكفؤا قدمت عليه مع أن حقها التأخر عنه للاهتمام بها لأن المقصود نفي المكافأة عن ذاته تعالى أي لم يكافئه دو لم يماثا ولم يشاكله بل هو خالق الأكفاء ويجوز أن يكون من الكفاءة في النكاح نفيًا للصاحبة وأما تأخير اسم كان فلمراعاة الفواصل ولعل ربط الجمل الثلاث بالعاطف لأن المراد منها نفي أقسام الأمثال فهي جملة واحدة منبه عليها بالجمل.قال القاشاني: ما كانت هويته الأحية غير قابلة للكثرة والانقسام ولم تكن مقارنة الوحدة الذاتية الغيرها إذا ما عدا الوجود المطلق ليس إلا لعدم المحض فلا يكافئه أحد إذ لا يكافئ عدم الصرف الوجود المحض.وقال بعضهم: كاشف الوالهين بقوله هو وكاشف الموحدين بقوله الله وكاشف العارفين بقوله أحد والعلماء بقوله الصمد والعقلاء بقوله:
{لَمْ يَلِدْ}.. الخ.وهو أي لم يلد إشارة إلى توحيد العوام لأنهم يستلدون على المصانع بالشواهد والدلائل وقال بعض الكبار إن سورة الإخلاص إشارة إلى حال النزول وهو حال المجذوب فأولًا يقول هو الله أحد الله الصمد.. الخ.وحال الصعود يعتبر من الآخر إلى جانب هو فيقول أولًا لم يكن له كفؤا أحد ثم يترقى إلى أن يقول هو لكن لا ينبغي للسالك أن يكتفي بوجدان هو في القرآن بل ينبغي له أن يترقى إلى القرآن الفعلي فيشاهد هو في القرآن وهو محيط بالعوالم كلها وهو أول ما ينكشف للسالك ولاشتمال هذه السورة مع قصرها على جميع معارف الإلهية والرد على من الحد فيها جاء في الحديث إنها تعدل ثلث القرآن فإن مقاصده منحصرة في بيان العقائد والأحكام والقصص ومن عدلها بكله اعتبر المقصود بالذات منه وهو علم المبدأ وصفاته إذ ما عداه ذرائع إليه وقال عليه السلام: أسست السموات السبع والأرضون السبع على قل هو الله أحد أي ما خلقت إلا لتكون دلائل على توحيد الله ومعرفة صفاته التي نطقت بها هذه اسورة وعنه عليه السلام، سمع رجلًا يقرأ قل هو الله أحد فقال: وجبت فقيل وما وجبت يا رسول الله قال وجبت له الجنة وعن سهيل ابن سعد رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي عليه السلام وشكا إليه الفقر فقال إذا دخلت بيتك فسلم إن كان فيه أحد وإن لم يكن فيه أحد فسلم على نفسك واقرأ قل هو الله أحد مرة وحدة ففعل الرجل ذلك فأدر الله عليه رزقًا حتى أفاض على جيرانه وعن علي رضي الله عنه إنه قال من قرأ قل هو الله أحد بعد صلاة الفجر إحدى عشرة مرة لم يلحقه ذنب يومئذٍ ولو اجتهد الشيطان وفي الحديث أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة واحدة فقيل يا رسو الله من يطيق ذلك قال أن يقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات وروى إنه نزل جبريل عليه السلام بتبوك فقال يا رسول الله إن معاوية بن المزني رضي الله عنه مات في المدينة أتحب أن أطوي لك الأرض فتصلي عليه قال: نعم فضرب بجناحه على ورض فرفع له سريره وصلى عليه وخلفه صفان من الملائكة كل صف سبعون الف ملك ثم رجع فقال عليه السلام بم أدرك هذا قال بحبه قل هو الله أحد وقراءته إياها جائيًا وذاهبًا وقائمًا وقاعدًا وعلى كل حال رواه الطبراني وصحب سورة الإخلاص حين نزلت سبعون ألف ملك كلما مروا بأهل سماء سألوهم عما معهم فقالوا نسبة الرب سبحانه ولهذا سميت هذه اسورة نسب الرب كما في كشف الأسرار وسميت سورة الإخلاص لإخلاص الله من الشرك نسب الرب كما في كشف الأسرار وسميت سورة الإخلاص لإخلاص الله من الشرك أو للخلاص من العذاب أو خالصة في التوحيد قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى:
عفو ربي وثيقتي بالخلاص** واعتصامي بسورة الإخلاصأو لأنها سورة خالصة ليس فيها ذكر شيء من الدنيا والآخرة وقال الحنفي لأنها تخلص قارئها من شدائد الآخرة وسكرات الموت وظلمات القبر وأهوال القيامة.وقال القاشاني: لأن الإخلاص تمحيض الحقيقة الأحدية عن شائبة الكثرة. اهـ.